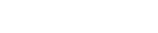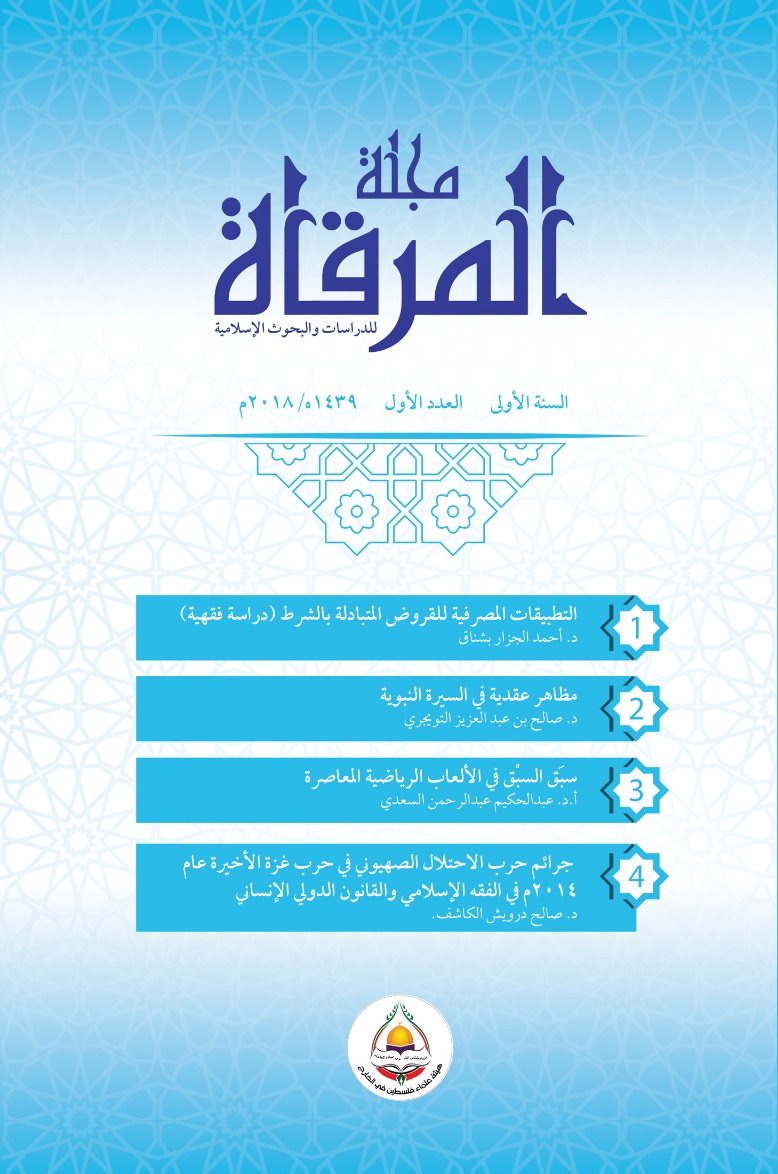خاص هيئة علماء فلسطين
(معركة طوفان الأقصى نموذجًا)
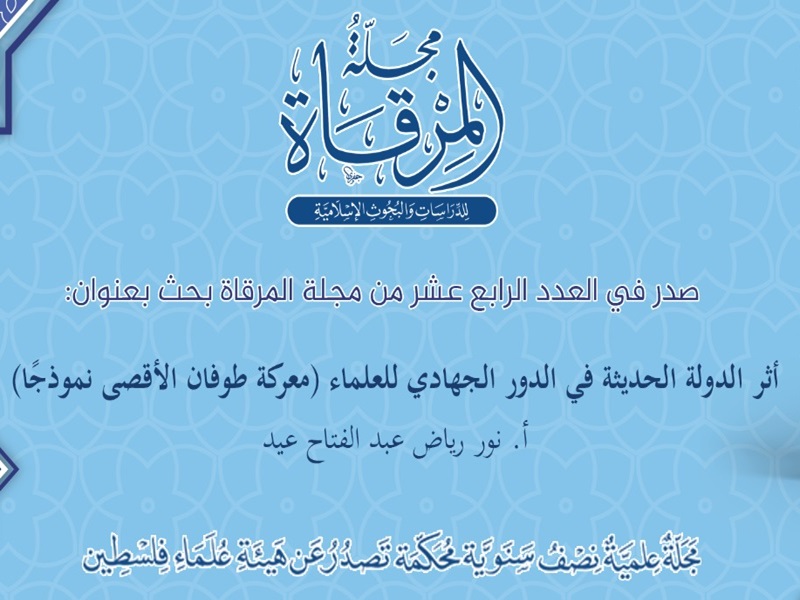
إعداد الباحث: نور رياض عبد الفتاح عيد [1]
الملخص:
يتناول البحث قضية واقعية ذات أبعاد سياسية، وشرعية، وهي بيان أثر الدولة الحديثة في الدور الجهادي للعلماء، وهو ينطلق من التسليم بضعف دور الأمة وعلمائها في نصرة الشعب الفلسطيني أثناء حرب الإبادة التي يتعرض لها، وأظهر الباحث الدور الجهادي المطلوب من العلماء، وكشف عن طبيعة الدولة الحديثة، وذكر عدة وسائل تتمكن الدولة الحديثة بواسطتها من التأثير في العلماء، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي، والتحليلي، وخلص لمجموعة من النتائج، منها: إن عدم الانتباه لما تحمله الدولة الحديثة من فكر وإمكانيات، والتعامل معها على أنها محايدة، جعل بعض المسلمين ينظرون إلى سهولة أسلمة الدولة والمجتمع بمجرد السيطرة على السلطة، كما سعت الدولة الحديثة لتفكيك الأبنية الاجتماعية المتوارثة، بما فيها الأسرة التي كانت تشكل اللبنة الأهم في المجتمع، وهذا ما جعل الناس أبناء دولهم أكثر من كونهم أبناء أهليهم، ومجتمعهم، ودينهم، مما انعكس سلبًا على العلماء، وأفقدهم بعض عوامل قوتهم.
Abstract:
This study examines a real-world issue with political and religious dimensions, explicitly analyzing the impact of the modern state on the jihad-related role of religious scholars. It begins with the premise that both the Muslim community and its scholars have played a weakened role in supporting the Palestinian people amid the genocide they are facing. The researcher elucidates the jihad-related responsibilities expected of scholars, explores the nature of the modern state, and identifies several mechanisms through which the modern state influences scholars.
Employing both descriptive and analytical methodologies, the study arrives at several key findings. Among them is the observation that failure to recognize the ideological underpinnings and capacities of the modern state—alongside the mistaken assumption that the state is neutral—has led some Muslims to believe that Islamizing the state and society is easily achievable merely by seizing political power. Additionally, the modern state has actively worked to dismantle inherited social structures, including the family unit, which historically served as the fundamental pillar of society. Consequently, individuals have become more aligned with their states than with their families, communities, and religious identities. This shift has had a detrimental impact on religious scholars, weakening their traditional sources of authority and influence.
مقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد..
فقد وضعت معركة طوفان الأقصى[2] العديدَ من القضايا على طاولة البحث، وأعادت التساؤلات حول كيفية إحياء فعالية الأمة الإسلامية، وشعوبها، وجيوشها، ونُخَبِها، فرغم كثرة المجازر وفظاعتها التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني، والأعداد الكبيرة للشهداء والجرحى والأسرى والنازحين، والدمار الهائل الذي لحق بغزة، وطول أمد الحرب، وتجاوز الكيان الصهيوني لكل الخطوط الحمر، إلا أن فِعْلَ الأمة المسلمة -شعوبًا وحكومات- كان أقل من الحدث بكثير، بصورة أظهرت مقدار الضعف والوهن الذي يسكن هذه الأمة، ومن الفئات التي ظهر ضعفها العلماء والفقهاء، فقد ظهر أهل العلم بين ساكت متألم يشعر بالعجز، وساكت ينتظر الإذن من حكومته ليردد ما تقوله، وآخر غير مهتم بقضايا الأمة حابسًا نفسه بين الكتب، وهناك من هاجم المقاومة الفلسطينية ووقف ضدَّها، وهناك علماء خطبوا، وكتبوا، وأفتوا، ونظموا الفعاليات المناصرة للفلسطينيين، وجمعوا الأموال لصالح الشعب الفلسطيني، لكن تأثير عملهم كان دون المأمول، ولم يرتقِ لمستوى الحدث، ولا يوجد دليل على هذا التقصير أكثر من استمرار شلال الدم الفلسطيني هذه المدة الطويلة، وعلى الرغم من أن الأمة مقصِّرة في قضية فلسطين منذ نكبتها سنة 1948م، إلا أن هذه الأيام أظهرت خذلانًا وتقصيرًا كبيرين.
إن هذا التخاذل العربي والإسلامي الواضح تتحمل مسئوليته الأنظمة العربية والإسلامية أولًا، فهي المسئول الأول والأكبر عن حالة الضياع والتيه والضعف والهوان التي تعيشها أمتنا، ولكن هذا لا يعفي من التساؤل عن دور علماء الأمة، ومؤسساتها العلمية، حيث كان من المتوقع أن يكون لهم دورٌ واضحٌ ومُؤَثِّرٌ في نصرة الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال تحريك الأمة، والتأثير في الحكومات للقيام بالمطلوب منها أو فعل شيء يوقف المذبحة على الأقل، هذا فضلًا عن حث الجيوش على القيام بواجبها في الدفاع العسكري عن شعبٍ مسلمٍ مظلومٍ.
وإن محدودية دور العلماء وضعفه يرجع لمجموعة من العوامل، اقتصر الباحث على دراسة أحدها -الذي ربما يكون أهمها وأخطرها- وهو تأثير الدولة الحديثة، وقد جاء البحث بعنوان: أثر الدولة الحديثة في الدور الجهادي للعلماء، وينطلق البحث من التسليم بضعف دور العلماء ومحدوديته في هذه الحرب، ولا يمكن ادعاء قيام العلماء بدورهم طالما أن المحصلة النهائية هي هذا الخذلان الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، حتى تُرِك ليواجه مصيره وحده، ولم تستطع الشعوب المسلمة كسر الطوق الذي فرضته عليها الأنظمة الحاكمة، ورغم وجود مخلصين كثر في الأمة المسلمة إلا أن القبضة الأمنية للأنظمة الحاكمة منعت هؤلاء من القيام بالدور المنشود في نصرة شعب فلسطين، وفي نصرة شعوب مسلمة أخرى في أوقات سابقة.
أهمية الموضوع:
تكمن أهمية الموضوع في النقاط الستِّ الآتية:
- حاجة الأمة الإسلامية لمواصلة الجهاد؛ لأنها مستضعفة، ولا تزال تتعرض لعربدة قوى الاستكبار بصور متعددة.
- حاجة الشعب الفلسطيني للنصرة، والتحرير، والدعم.
- محدودية الدور الذي تقوم به الأمة بكافة فئاتها تجاه قضاياها المختلفة، في ظل قدرة دولة الاحتلال على تفعيل أكبر قدر من الطاقات لصالحها.
- ضعف دور العلماء في قضايا الأمة المختلفة، مما أدى لضعف أثرهم، واهتزاز الثقة بهم.
- معاناة الشعوب الإسلامية من سيطرة الدولة الحديثة، التي تتحكم فيها أنظمة القهر والاستبداد، مما ألحق بها أضرارًا كثيرةً.
- تَعَرُّض شعوب الأمة الإسلامية لمخطَّطات عديدة لإبعادها عن دينها، وسلخها عن هويتها، وضعف التصدي لذلك.
أسئلة البحث:
– ما طبيعة الأعمال الجهادية التي يمكن أن يقوم بها الفقهاء؟
– ما طبيعة الدولة الحديثة؟
– ما وسائل الدولة الحديثة التي تؤثر بها في العلماء؟
أهداف البحث:
يتطلع هذا البحث لتحقيق الأهداف الثلاثة الآتية:
- بيان الدور المطلوب من علماء الأمة في قضايا الجهاد، ونصرة المستضعفين.
- الكشف عن طبيعة الدولة الحديثة التي تحكم الأمة.
- بيان أدوات التأثير التي تملكها الدولة الحديثة، وتتمكن من خلالها من التأثير في العلماء.
مشكلة البحث:
تتلخص مشكلة البحث الرئيسة في الكشف عن أثر الدولة الحديثة في الدور الجهادي للعلماء، حيث إن الدولة الحديثة لها آثار في العديد من مجالات الحياة، فهل كان العلماء ممن وقع تحت تأثير هذه الدولة؟ ويتفرع عن هذا الإشكال الرئيس إشكالات أخرى، منها: بيان الوسائل التي استُخْدِمَت في التأثير فيهم، والأدوار التي كان من المأمول أن يقوم بها العلماء -خاصة ما يتعلق بالجهاد- ومنعتهم هذه الدولة من القيام بها.
منهج البحث:
سيعتمد هذا البحث على المناهج الآتية:
- المنهج الوصفي: الذي سيصف طبيعة الدولة الحديثة، ووسائلها، والإمكانات المتاحة أمامها، وسيصف كذلك الدور الذي يقوم به علماء المسلمين في أوقات الحروب التي تتعرض لها الأمة.
- المنهج التحليلي: حيث سيقوم الباحث ببيان طبيعة الدور الجهادي المطلوب من العلماء، وكذلك سيُظهر هذا المنهج كيفية تأثير أدوات الدولة الحديثة في العلماء.
خطة البحث:
اشتمل البحث على مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، وذلك على النحو التالي:
المقدمة: وتشتمل على أهمية الموضوع، وأسئلة البحث، وأهدافه، ومشكلته، ومنهجه، وخطته.
المبحث الأول: الدور الجهادي للفقيه.
المبحث الثاني: وسائل الدولة الحديثة في إضعاف دور العلماء الجهادي.
الخاتمة: وتحتوي على أهم النتائج والتوصيات.
والله أسأل أن يكون هذا البحث أحد الأسباب في تفعيل دور الأمة المسلمة لتعودَ خير أمةٍ أُخْرِجَت للناس، وأسأله تعالى أن يكون هذا العمل في ميزان حسناتي، وأن يغفر ما كان فيه من خطأ أو تقصير.
المبحث الأول: الدور الجهادي للفقيه
تشير التجربة الإسلامية إلى قيام الفقيه المسلم بأدوار عديدة ومهمات عظيمة في المجتمع المسلم، منها: الدور الإصلاحي، والتعليمي، والتربوي، والاجتماعي، والسياسي، والجهادي، فضلاً عن توليه مجموعة من المناصب المختلفة في الدولة، ومما دفع الفقيه للقيام بتلك الأدوار النصوص الشرعية الآمرة والمرغبة بتلك الأعمال، وفهمه لروح الدين الإسلامي الذي يهدف لإصلاح الحياة الإنسانية.
وقد منحت هذه الأعمال الفقيه مكانةً واحترامًا كبيرين لدى جماهير الناس، هذه المكانة اعتبرتها أم هارون الرشيد المـُلكَ الحقيقيَّ، فقد قدم عبد الله بن المبارك إلى الرَّقة مرة، فازدحم الناس حوله، فلما رأت أم هارون الرشيد هذا المشهد، قالت: “هذا هو الْمُلْكُ، لَا مُلْكَ هارُونَ الرَّشِيد الذى يَجمعُ النَّاسَ عَلَيْهِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا والرَّغبةِ والرَّهبة”[3]، فالفقيه لا يستمد مكانته من منصب سياسي معين، بل من حب الناس له، وثقتهم به، وقدرته على التأثير فيهم، فهو بالنسبة لهم مصدر توجيه وإرشاد خاصة في أوقات المحن والشدائد.
وسأقوم ببيان طبيعة المشاركة الجهادية التي يمكن أن يقوم بها العلماء اليوم، خاصة أن الأمر ليس بدعة، فقد كان للعلماء القدامى دورٌ واضحٌ في قتال أعداء الله، والدفاع عن أمتهم، وكذلك قام عددٌ من العلماء المعاصرين بذلك، ومن المأمول فقيه أن يكثر العلماء المعاصرون الذين يشاركون في الجهاد، خاصة في ظل تعرض عدد من الشعوب المسلمة للاحتلال، والظلم، سواء كان ذلك من الاستبداد الداخلي، أو من العدوان الخارجي، وليس مطلوبًا من كل عالم أن يقوم بكل هذه الأدوار، فالأمر يخضع للقدرات الشخصية، وتقدير المصالح والأولويات والموازنات، وغير ذلك، ومن هذه الأدوار:
- المشاركة الفعلية في القتال: إن الجهاد عبادةٌ مطلوبةٌ من كل مسلم عالمـًا كان أو متعلمًا بشروط معروفة في كتب الفقه، وقد جاءت في فضل الجهاد وعظيم منزلته آياتٌ وأحاديثُ كثيرةٌ، والمتوقع من العالم إذا جاءت نصوصٌ شرعيةٌ عديدةٌ تُرَغِّب في أمر من الأمور، وتوضح عظيم الأجر والثواب المترتب على فعله، أن يكون من أوائل الحريصين عليه، اقتداءً بقائد المجاهدين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن أبي هريرةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: “تَضَمَّنَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادًا فِي سَبِيلِي، وَإِيمَانًا بِي، وَتَصْدِيقًا بِرُسُلِي، فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مَا مِنْ كَلْمٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ حِينَ كُلِمَ، لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ، وَرِيحُهُ مِسْكٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْلَا أَنْ يَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ أَبَدًا، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ، وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً، وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوَدِدْتُ أَنِّي أَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ فَأُقْتَلُ، ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلُ، ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلُ”[4]، ومن العلماء الذين شاركوا في الجهاد في سبيل الله، وكانوا في صفوف المقاتلين: العالم القاضي أَسَدُ بنُ الفُرَاتِ (ت213ه)، الذي كان مع توسعه في العلم فارسًا، بطلًا، شجاعًا، مقدامًا، وقد أدركته منيَّتُه وهو أمير لأحد الجيوش الفاتحة لبلد من جزيرة صِقِلِّيَّة[5]، وقد جاء في ترجمة الإمام القَصَّاب (ت 360ه تقريبًا): “القَصَّابُ أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيِّ بنِ مُحَمَّدٍ: الإمامُ، العالِمُ، الحافظُ، أبو أحمدَ مُحمَّدُ بنُ عليِّ بنِ محمدٍ الكَرَجِيُّ الغَازِي المجاهدُ، وعُرفَ بِالقَصَّابِ لكثرةِ ما قتلَ في مَغازِيه”[6]، وكذلك الإمام المجاهد عبد الله بن المبارك، أمير المؤمنين في الحديث، الحافظ الغازي، صاحب البطولات، الذي كان كثير الغزو في سبيل الله[7]، وقد شارك الإمام البخاريُّ صاحب الصحيح في الجهاد، وعُرِف بالدقة في رمي السهام[8]، وكذلك الإمام ابن النحاس الدمشقي الذي استشهد سنة 814ه، وهو يقاتل الصليبيين في معركة الطينة، بعد أن أكثر من الرباط والجهاد، وقد ألف كتابًا حافلًا في الجهاد أسماه “مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق”، وكان قد سأل الله تعالى أن يرزقه أعلى رتب الشهادة في مقدمة كتابه، فأكرمه الله بما تمنى[9].
- الإنكار على المتخاذلين: إن مما يجب على أئمة الفقه والدين أن ينكروا منكر تقصير الأنظمة الحاكمة في نصرة الشعوب المظلومة، وبيان أن تقصير القادر على القتال في الدفاع عن إخوانه المسلمين هو ذنبٌ عظيم، ومنكرٌ كبير، وأن من يعجز عن النصرة العسكرية، فيجب عليه أن يبذل جهده في النصرة الاقتصادية، والإعلامية، والسياسية، كما عليهم ألا ينخدعوا بالنصرة الوهمية التي يكتفي أصحابها بالفتات، ظانين أنهم بذلك فعلوا المطلوب منهم وزيادة، هذا في المقصرين، فكيف بمن تثبت خيانته لله ورسوله والمؤمنين؟! وقد تطرق العلماء لمسألة منع الإمام الناس من الجهاد الواجب، فقد نقل ابن عليش عن ابن رشد قوله: “طاعةُ الإمامِ لازمةٌ، وإنْ كان غيرَ عَدْلٍ ما لَم يَأمرْ بمعصيةٍ، ومن المعصيةِ النَّهيُ عن الجهادِ الْمُتَعَيِّنِ”[10]، وقد حدث أن صَالحَ الملك الصالح إسماعيل الفرنج على أن يسلم لهم بعض حصون المسلمين، وسمح لهم بدخول دمشق لشراء السلاح لقتال المسلمين، فأفتى العز بن عبد السلام بحرمة بيع السلاح لهم، وتوقف عن الدعاء للصالح إسماعيل في خطبة الجمعة، فأمر باعتقاله، وفُرضت عليه الإقامة الجبرية في بيته، وأُمِرَ ألا يُفْتي، ولا يجتمع بأحد[11].
- التأليف والإفتاء في الجهاد: كتب العلماء الكثير في فضائل الجهاد، وأحكامه، سواء من خلال إفراده بالتأليف، أو كان ذلك ضمن مؤلفاتهم التي كانت في التفسير أو الفقه أو الحديث… إلخ، ومن المآخذ التي تسجل على الفقيه ألا يجاهد بقلمه، وأن يغفل عما تتعرض له أمته من ظلم واحتلال[12]، وقد كتب الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: “إن هناك مشتغلين بالعلم الديني، قاربوا مرحلة الشيخوخة أَلَّفُوا كتبًا في الفروع، وأثاروا معارك طاحنة في هذه الميادين.. ومع ذلك فإن أحدًا منهم لم يخط حرفًا ضد الصليبية، أو الصهيونية، أو الشيوعية”[13]، وإذا كان مما ترتفع به أسهم العالم هو عدد المسائل والفتاوى الواقعية التي صدرت عنه، فإنه مما تقاس به فاعلية علماء الشرع اليوم وانتماؤهم لأمتهم هو مقدار حديثهم عن العدو الصهيوني، الذي يحتل قلب العالم الإسلامي، ويحيك المؤامرات ضد جميع دوله، ويسعى لتفكيكه وإضعافه، ومن القضايا التي يجب أن تسلط عليها الأضواء، وأن تكتب فيها الكتب والفتاوى الكثيرة والمتكررة: كيفية إعداد الأمة للجهاد، وضرورة دعم حركات المقاومة، وتثبيت المرابطين في فلسطين، ومكانة القدس وأرض الإسراء، والكشف عن حقيقة اليهود المحتلين، وحكم التطبيع وخطورته، وحكم قعود جيوش الأمة عن نصرة الشعوب المظلومة، وحكم التعاون مع الاحتلال في حصار الشعب الفلسطيني، وحكم قيام الأنظمة الحاكمة باعتقال من يدعم المقاومة الفلسطينية، وحكم عزل الحاكم الذي يثبت تآمره مع أعداء أمته، …إلخ.
- تربية الأمة على العزة: إن الجهادَ أمرٌ ليس سهلًا، فهو طريق ذات الشوكة، ويحتاج لتربية نفوس أبناء الأمة على الشجاعة والإباء والعزة والكرامة، ومحاربة مظاهر الميوعة والخنوع، وهذا يكون من خلال عملية تربوية شاملة ومتكاملة، تشترك فيها كل المؤسسات، وتستخدم فيها كل الوسائل، فلا يمكن أن يربي الاستبداد أبطالًا، والشعوبُ التي تُرَبَّى على الخوف، وتعتاد الذل والتمسكن أمام رجل الأمن، وتبالغ في طاعة الحكام حد التقديس، لا يمكن أن تكون مستعدة لخوض الجهاد الصعب الشاق.
- تحريض الأمة على القتال وإعدادها فكريًا له: ينبغي أن تكون فكرة الجهاد حيةً وحاضرةً لدى جميع أبناء الأمة، وهذا يتطلب أن يكون تدريس باب الجهاد أمرًا أساسيًا في الثقافة الإسلامية، فتُسْتَحضر آيات الجهاد، وأحاديثه، وغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، وفتوحات المسلمين من بعده[14]، وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم أن يحث أتباعه على القتال في سبيل الله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ…﴾ [سورة الأنفال: 65]، ومن هذا التحريض حث الأنظمة والجيوش الرسمية على القيام بدورها، فالمسلمون أمة واحدة، ونصرة المستضعفين واجب شرعي، وجهاد شعب فلسطين هو جهاد دفعٍ؛ لأن العدو احتل أرضهم، واعتدى عليهم، ويترتب على ذلك أنه يجب على كل مسلمٍ قادرٍ أن يقوم به، ويبدأ وجوب مقاومة العدو الكافر على أهل فلسطين، فإن عجزوا وجب على مَن بجوارهم من المسلمين أن يشاركوا معهم في القتال، وتبقى الدائرة تتسع حتى تحصل الكفاية، وإن قصّر المسلمون بذلك فهم آثمون[15]، ولذلك فإن الاشتباك مع العدو الصهيوني يجب أن يكون في كل مكانٍ يمكن فيه ذلك، وقد كان العلماء قبل عقود يدعون الناس ويقودونهم للتظاهر أمام سفارة الكيان الصهيوني -التي من المفترض ألا تكون موجودة أصلًا- وسفارات الدول الداعمة له، ويطالبون الرؤساء بطردهم، وإغلاقها، ليكون الضغط الكبير لوقف العدوان، لكن هذه الأصوات باتت خافتة في هذه الأيام، وبيانات العلماء خجولة.
- تربية المجاهدين وترشيدهم: يحتاج العمل الجهادي إلى العلماء الربانيين، الذين يفهمون واقع الجهاد وخفاياه، ويقتربون من المجاهدين، فيربونهم، ويعلمونهم، ويقوِّمون أخطاءهم، فالجهاد يترتب عليه خوضُ حروبٍ، وسفكُ دماءٍ، وتدميرُ مقدرات… إلخ، فلا يجوز أن يقوم به الجاهل، أو الـمُتَهوِّر، وكذلك لا يحسن أن يفتي به البعيد عنه، ولا غير المهتم بفهم الواقع السياسي وتعقيداته، وقد وردت آيات قرآنية وأحاديث نبوية عديدة، تصحح أخطاء المجاهدين، وتأمرهم بتقوى الله، وقد نزلت سورة الأنفال في أعقاب غزوة بدر، وقد بدأت بقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأنْفَالِ قُلِ الأنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين﴾[سورة الأنفال: 1].
- تقديم الدعم المادي للمجاهدين: يحتاج الجهاد لدعم مادي كبير، فهو يحتاج لتكاليف باهظة سواء في مرحلة الإعداد، أو خوض المعارك، أو لمعالجة آثار الحروب، ولذلك جعل القرآن الجهاد في سبيل الله أحد مصارف الزكاة الثمانية: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾[سورة التوبة: 60]، كما حث النبي صلى الله عليه وسلم على دعم الجهاد والمجاهدين، فعنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: “مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ، فَقَدْ غَزَا”[16]، والمأمول من العالم أن يكون أول من يدفع ماله، ومن ثم يُذَكِّر الناس لا سيما الأثرياء منهم بوجوب تقديم المال لأهل الجهاد، وكذلك عليه أن يحث على كفالة أسر الشهداء؛ “لتطِيبَ قلوبُ الـمجاهدين، لأنَّهم إذَا علموا أَنَّ عيالَهم يُكْفَوْنَ الْمُؤْنَةَ بعد موتِهِم تُوَفَّرُوا على الجهادِ بخلافِ عكسِه”[17]، وهذا لا ينحصر اليوم في أهالي الشهداء فهناك عوائل الأسرى، والجرحى الذين أمسوا عاجزين عن العمل، وكذلك أصحاب البيوت المدمرة، …إلخ.
- الدعم المعنوي للمجاهدين: وذلك من خلال الثناء على أهل الجهاد، وإظهار مناقبهم، والدفاع عنهم، والتماس الأعذار لهم، ومن خلال المشاركة بل قيادة الجماهير في المسيرات والفعاليات الداعمة للجهاد والمجاهدين، وتوجيه وسائل الإعلام لذلك، واستثمار طاقات الأمة في نصرة الجهاد، ومن المطلوب اليوم تنحية الخلافات جانبًا في وقت احتدام المعركة، والتركيز على نقاط الاتفاق، وتوحيد الأمة نحو العدو المجرم، وإذا كانت الأمة قد أجمعت على أنه يُجَاهَد مع الإمام البر والفاجر[18]، فالمعنى المراد أنه عند تعرّض الأمة لخطر داهم من الخارج، فإن الخلافات الأخرى تصبح هامشية، ويجب أن تطوى حتى تتخلص الأمة من الخطر الخارجي الذي يريد استئصالها، لا أن تستحضر تلك الخلافات لتخذيل الناس، ومنعهم من نصرة إخوانهم، بل وتزهيدهم في التعاطف معهم.
وعند التأمل في الأدوار المذكورة التي يجب على العلماء القيام بها، نجد أن عددًا منها لا يقوم العلماء بها، وبعضها يقومون به لكن بشكل محدود، وبما تسمح به في الغالب الأنظمة الحاكمة، وإنَّ عددًا ممن قام بها أو حاول القيام بها، فُرِضَت عليه عقوبات، وهذا يوجب التساؤل عن أسباب ذلك، وما يراه الباحث أن أحد الأسباب هو هذه الدولة الحديثة.
المبحث الثاني: وسائل الدولة الحديثة في إضعاف دور العلماء الجهادي
تمهيد: طبيعة الدولة الحديثة
لم تحظَ الدولة الحديثة -في حدود علمي- بدراسات كثيرة من قِبل الكُتّاب المسلمين، وتكاد أن تكون من أقل القضايا السياسية التي انتبه لها الباحثون والساسة الإسلاميون، فهم اهتموا ببيان الحكم الشرعي للعديد من منتجات هذه الدولة، كدراستهم لحكم الانتخابات، والديمقراطية، والمشاركة في المجالس النيابية، وتولي المرأة وغير المسلمين للمناصب العليا، والتحالفات السياسية بين المسلمين وغيرهم،… إلخ، إلا أن الدولة الحديثة نفسها لم تأخذ حقها في الدراسة، وأحسب أن السبب الرئيس لذلك هو عدم الانتباه إلى أنّ هذه الدولةَ شيءٌ مستحدثٌ جاء به الغرب، بل اعتبروها امتدادًا طبيعيًا للدولة الإسلامية التقليدية التي كانت تحكم العالم الإسلامي، فالشق الذي دارت حوله الدراسات في موضوع الدولة الإسلامية، هو ما يتعلق بـ (الإسلامية)، “علمًا أن علة البحث في الدولة الإسلامية هو شق الدولة وليس شق الإسلامية”[19].
ونتيجةً لعدم الانتباه للدولة الحديثة، وما يكمن فيها من علل، ظن بعض الإسلاميين أن التحول الذي لحق بالأمة الإسلامية في العصر الحديث هو بسبب سيطرة أنظمة سياسية لا تحكم بالشريعة على مؤسسات الدولة، فالدولة في نظرهم حصن يمكن الاستيلاء عليه، وبمجرد أن يستولي عليه ساسة مسلمون، تتحول إلى دولة تطبق النظام الإسلامي الذي يتطلع له المسلمون، فهم يرون أن المطلوب هو أسلمة ما في الدولة فحسب، ولم ينتبهوا إلى منطق هذه الدولة وفكرها وهياكلها، وقدرتها الكبيرة على ابتلاع الأيديولوجيا والأخلاق لصالح الهيمنة والتحكم ورأس المال[20].
ومنذ قرابة قرنين تقريبًا، احتل الغرب العالم الإسلامي، وكان مما جاء به وتركه وراءه الدولة الحديثة، فقد ورث حكام العالم الإسلامي من أوروبا دولة قومية جاهزة بكل هياكلها، وهي دولة ذات مرجعية وستفالية –نسبة إلى صلح وستفاليا الذي حدث بين الدول الأوروبية سنة 1648م- واتبعوا السياسة الاستعمارية التي كانت الشعوب تحاربها قبل الاستقلال، هذه الدولة بصورتها الكاملة القادمة من الغرب لها تطلعات وغايات تختلف عن الدولة الإسلامية، حيث يتحالف فيها رأس المال الصناعي مع النخب العسكرية مما يؤدي إلى حماية مشددة لهذه الدولة تطيح بأي قوة شعبية من الممكن أن تؤثر فيها حتى لو جاءت عبر صناديق الاقتراع، وتحتل الشؤون الاقتصادية والعسكرية فيها الأولوية على أي أمر آخر[21]، ويرى إبراهيم البيومي غانم أن الدولة الحديثة بمفهومها الوافد هي علة العلل، وبيت الداء وأصل الدواء، وأنها تسببت في وقوع أمتنا في الكثير من الأزمات، والمعضلات، والانتكاسات الكبرى[22].
والدولة الحديثة ليست آلةً صماء أو محايدة، بل هي تحمل فكرًا وثقافةً، وتترك آثارها في كافة مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والنفسية، وهي تصوغ نظمًا معرفية تسهم في تشكيل حياة الأفراد والمجتمع إلى حد كبير، ولا يمكن فهمها بعيدًا عن مشروعها وآلتها الرأسمالية، وقد أدرك الاستعمار أن المعايير الأخلاقية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية تتعارض مع الحداثة ودولتها، لذلك سعى لإفراغ الشريعة من مضمونها، وأعيد تشكيلها بما يتواءم مع الدولة الحديثة[23]، ويرى بعض الدارسين أن إمكانية إقامة الدولة الإسلامية المنشودة على هياكل الدولة الحديثة أمرٌ ليس سهلًا ولا ميسورًا، إن لم يكن مستحيلًا، والتناقض بين نظام الحكم الإسلامي، والدولة الحديثة لا يرجع للشريعة بل لمأزق الحداثة الأخلاقي، فالحداثة تصنع بيئة أخلاقية لا تواتي النظام الإسلامي، ولا تلبي أدنى معاييره[24].
ويظهر أن هناك موقفين لدى الباحثين من إمكانية إقامة النظام الإسلامي على هيكل الدولة الحديثة، أولهما مَن يرى صعوبة أو استحالة ذلك، وثانيهما مَن يرى إمكانية ذلك بشرط أن تلتزم الدولة بالقيم السياسية الإسلامية، ولا تكون أسيرة للشكل التاريخي[25]، ويرى الباحث أن الأمر يحمل الكثير من الصعوبات والتعقيدات خاصة في ظل النظام العالمي المـُهيمن، وفي ظل ضعف المسلمين، ولكن الوصول لدول إسلامية أفضل من الدول القائمة أمرٌ ممكنٌ، إذا سعى المسلمون لذلك بجد وصدق وفهم، وإن كانت هذه الدول لن تتحرر من كل سلبيات الدولة الحديثة وقيودها، وإن التخلص من الدولة الحديثة وهدم هياكلها أمرٌ صعبٌ ومُعَقَّدٌ -هذا على اعتبار إمكانه في هذا الوقت- لكن ما يراه الباحث مُهمًا هو الانتباه لهذه القضية، وفهمها، وإدراك أبعادها، والعمل على التَّفَلُّت من سلبياتها بالتدرج.
ويتجاوز هذا البحث التخوفات التي يبديها بعض الباحثين من أن الحديث عن استحالة قيام الدولة الإسلامية على هياكل الدولة الحديثة، يصنع حالة من اليأس والعزلة عن العمل السياسي، أطلق عليها الشنقيطي: “الرهبانية السياسية” التي سيكون مآلها إلى العلمانية الصريحة[26]، وبعيدًا عن مدى دقة هذه التخوفات، فإن غاية البحث هي عكس ذلك، بل هي دعوة العلماء للمدافعة السياسية لكسر الطوق المفروض عليهم لتفعيل دورهم المنشود في نصرة الشعب الفلسطيني وبقية قضايا الأمة، وذلك من خلال فهم أعمق للواقع الذي نحياه، كما أن الهدف ليس إلغاء السلطة أو استمرارية التصادم معها في المجتمع المسلم، فالمجتمع المسلم لا يسعى لإلغاء سلطته الحاكمة، وتدميرها، والسلطة المسلمة لا تعمل على إضعاف مجتمعها، وكسره، بل العلاقة ينبغي أن تكون علاقة تعاون وتناصر لتتحقق الأمة المؤمنة المنشودة.
وسائل الدولة الحديثة في إضعاف دور العلماء الجهادي:
تمتلك الدولة الحديثة مجموعة من الأدوات والوسائل التي تمكنت من خلالها من إحكام السيطرة على المجتمع كله، وتقليص دوره، وانعكس هذا بصورة واضحة على العلماء، وأعني بالوسائل هنا ما يتعلق بخصائص هذه الدولة، ومكوناتها الأساسية التي أمست ترسم صورتها اليوم، وأما الروح العلمانية الليبرالية فلن يتطرق لها البحث إلا قليلًا، فهي تحتاج لدراسات أخرى.
وقبل ذكر الوسائل التي تمتلكها الدولة الحديثة، فإنه من المهم الإشارة إلى أنّ بعض هذه الوسائل هي سلاح ذو حدَّين، وقد يكون لها إيجابيات، لكن أيضًا لها سلبيات تستخدمها السلطات بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الإضرار بمصالح أمتنا، وشعوبها، ولذلك سيُظهر البحث الوجه السلبي لهذه الوسائل؛ لتعلقها بموضوع البحث، ومن هذه الوسائل التي أثّرت في دور العلماء الجهادي، ما يلي:
- شمولية الدولة الحديثة: لم تكن الدولة القديمة تسيطر على كثير من الأمور، بل كانت محدودة الصلاحيات، وتتحرك في مساحات ومجالات معينة، وكانت المساحة والصلاحيات الأكبر بيد المجتمع، فكان المجتمع يدير نفسه بنفسه، بل إن بعض القرى والبلدات البعيدة عن العاصمة لم تكن تهتم كثيرًا بالأحداث السياسية، ليس كسلًا منها، بقدر ما هو نوع من الاستغناء عنها، أو عدم تأثرها الكبير بالتغيرات السياسية التي تحدث.
كانت الدولة القديمة لا تحضر أحيانًا إلا إذا استُدعِيت، أما اليوم فلا يمكن لأي شيء أن يحدث بعيدًا عن الدولة ومؤسساتها، وهي تمارس نوعًا من الوصاية على الناس وكأنهم قُصَّر وإن ادّعى القائمون على الدولة خلاف ذلك، فالدولة الحديثة تبسط نفوذها على التعليم، والصحة، والسفر، والضرائب، والترفيه، وكل شيء تقريبًا، ولو قارَنَّا بين حياة إنسان في الدولة القديمة وإنسان اليوم ستظهر لنا الفروق بوضوح، فقد كان الزواج يحدث دون أيِّ وثيقة رسمية تصدر عن الدولة، وتتم الولادة داخل البلدة دون استصدار شهادة ميلاد، ثم ينشأ ويتربى الطفل بين أهله، ثم يلتحق بالكُتَّاب ليتعلم القراءة والكتابة وأمور دينه، وكان شيخ الكُتَّاب يتقاضى أجرته إما من الأوقاف الخيرية، أو من أهالي الطلبة، ثم يلتحق المرء ببعض المدارس والجامعات التي لا تتدخل الدولة في مناهجها التدريسية، أو يتعلم حرفة أهله التي قد يعمل فيها بقية عمره، أو يتعلم عملًا جديدًا، وإذا توفي قام أقاربه وأهل بلده بشؤون دفنه، ويدفن في مقبرة بلده التي هي في الغالب ملكٌ لعائلته أو وَقَفَها بعض المحسنين، وهو ليس بحاجة لشهادة وفاة من الدولة، إلى غير ذلك من أمور الحياة التي قلما يحتاج فيها للاقتراب من الدولة ومؤسساتها، بينما في الدولة الحديثة لا يكون الزواج معترفًا به إلا بوثيقة رسمية صادرة عن الدولة، وإنجاب الأطفال لا بد أن تعلم به الدولة كي تصدر له شهادة ميلاد، وإلا فهو إنسان بلا اعتراف رسمي، ولا حقوق، ولا هوية شخصية، ولا جنسية، ولا جواز سفر، ثم تستمر كل أمور حياته بالتصاق شديد بالدولة، ولا يمكنه بحال الاستغناء عنها، وقد تتدخل الدولة –بصورة واضحة أو خفية- في تحديد سن الزواج، وعدد أفراد الأسرة، وتشجيع الطلاق، وكثير من أمور حياة الناس، وبالفعل فقد أحكمت الدولة الحديثة قبضتها إحكامًا تامًا على المجتمع، وقضت على تنظيماته الأهلية ومؤسساته التطوعية، وصار أي نزوع اجتماعي نحو تكوين مؤسسات تطوعية مستقلة عن الدولة يصطدم –بدرجة أو بأخرى- بمنطق الدولة المركزية[27].
والفقيه فرد من أفراد هذا المجتمع الذي تمتد الدولة في جميع قنواته، لذلك فإن المساحة التي يستقل فيها العلماء عن الدولة محدودة جدًّا، وأكتفي بذكر شيء يسير عن سيطرة الدولة الحديثة على بعض المؤسسات المؤثرة:
- كانت مؤسسات التعليم في الدولة الإسلامية القديمة بعيدة عن السلطة، وحتى المدارس التي بناها السلاطين والوزراء فلم يكن لهم تأثير على المواد التي تُدرَّس، بل ظلت موضوعات التعليم هي المهمة لفهم الشريعة، ولإشباع حاجات المجتمع، أي التي تحقق متطلبات الحياة الفاضلة، وتحقق للناس سعادة الدارين، وهو ما جعل المتعلمين من أبناء المجتمع من إنتاج الشريعة وليس الدولة الحديثة[28]، أما اليوم فإن الفقيه يدرس في المدارس والجامعات التي تخضع لرقابة الدولة، وتضع لها مناهجها، وتعليم الدولة في نهاية المطاف يعكس رؤيتها، وأهدافها.
- تسيطر الدولة الحديثة بصورة شبه كلية على الإعلام، مما يمكن الحكومات الفاسدة من منع العلماء المخالفين لها من الظهور على وسائل إعلامها، أو تشويههم إعلاميًا، وإلصاق أقذع التهم بهم، من التخوين، والتبديع، والتهور، والعمل لمصلحة جهات خارجية،… إلخ، وتتمكن السلطات اليوم من خلال الإعلام وبقية المؤسسات من تشويه الوعي المجتمعي، إذ تقدم روايتها للجمهور من خلال كثافة الأخبار والبرامج التي تقدمها، حتى تجعل عدوًا يبدو صديقاً، وهكذا، كما إن الإعلام اليوم يشغل العلماء والناس بقضايا غير مهمة، لتستفرد السلطات بفعل ما تريده في القضايا الكبرى، وإضافة لإشغال الناس بسفاسف الأمور والمحرمات، تُحيا المسائل الدينية التي لا يُبْنى عليها كبير عمل، والتي لا تحتل أولوية بينما تتعرض البلاد لخطر الاحتلال الصهيوني الذي يهدد دينها، وثقافتها، وحياتها، وخيراتها، وقد قال الشيخ محمد الغزالي لمن جاء يناقشه في قضايا عقدية اختلف فيها السلف قديمًا: “لماذا تحيون الخصومات العلمية القديمة؟ كانت هذه الخصومات -ودولة الإسلام ممدودة السلطة- خفيفة الضرر، وإنكم اليوم تجددونها ودولة الإسلام ضعيفة، بل لا دولة له، فلِمَ تعيدونها جذعة، وتسكبون عليها من النفط ما يزيدها ضرامًا؟ وَجِّهوا الأمة إلى كتاب ربها وسنة نبيها، وأشغلوهم بما اشتغل به سلفنا الأول، اشتغل بالجهاد في سبيل الله فاعتز وساد مع ملاحظة أنهم يحررون غيرهم، أما نحن فمكلفون بتحرير أنفسنا”[29].
- وأما المؤسسات الدينية فقد احتوتها الدولة الحديثة احتواءً شبه كامل، فلها وزارة أوقاف وشؤون دينية، وهي المسؤولة عن المساجد، فتتحكم في أوقات فتحها، وأوقات إغلاقها، وتوظف العاملين فيها من أئمة، وخطباء، ومؤذنين، وتلزمهم بتنفيذ سياستها، حتى أن خطبة الجمعة يقرؤها الخطيب عن ورقة تأتيه من الجهات العليا، وهي المسيطرة على الجامعات والمدارس الدينية، وهي من تُعيّن المفتي الرسمي للدولة، وهذا كله يمكنها من صبغ أي فكرة أو مشروع تؤيده بالصبغة الشرعية، فالدولة الحديثة تستخدم الدين ولا تخدمه.
- اتساع مساحة الإلزام في الدولة الحديثة: إضافة للشمولية، فإن كثيرًا من الأمور التي كان الفرد في القديم مخيرًا فيها، أصبح اليوم ملزمًا بها، ومعاقبًا على مخالفتها، فهذه الدولة لها نزوع دائم للتدخل المتزايد في كافة شؤون المجتمع، وإخضاعه لها، وذلك بما أتيح لها من سلطات، وأجهزة إدارية لم تكن متاحة للدولة قبل العصر الحديث[30]، فالدولة الحديثة تعاقب أي فرد ممكن أن يتخلف عن قتال تدعوه لها بعد أن صُنِعت الجيوش النظامية، فلا يُقْبَل أي مبرر شرعي أو أخلاقي للتخلف عن نداء الدولة حتى لو كان هذا القتال محرمًا، فلا يجوز لأحد أن يدعوَ لغير ذلك، ورغم أن كثيرًا من الأمور بدأت في الدولة الحديثة تخييرًا، إلا أنها آلت إلى الإلزام، وترتب على الشمولية والإلزامية أن تتقلص مساحات العمل الشعبية، وأن يضمر الفعل المجتمعي، فصارت قوة الأشياء وضعفها تتبع إلى حد كبير مقدار تبني الدولة له، وفضلاً عن محدودية الدور المسموح به للمجتمع، فإن بعض الحكومات يسعدها أن يكون المجتمع خاملًا، ومنعزلًا عن التأثير في المجال العام، فلا تستدعيه، وتقضي الأمر في غيابه.
وقد ظهرت آثار شمولية الدولة الحديثة وإلزاميتها في معركة طوفان الأقصى، فإذا كان النظام الحاكم داعمًا ومناصرًا لفلسطين كان الحراك الشعبي كبيرًا، والعكس صحيح، والأصعب أن يكون النظام الحاكم ليس متخاذلًا بل معاديًا للفلسطينيين، ودور العلماء وأئمة المساجد والمؤسسات الدينية في مناصرة غزة كان في حدود ما تسمح به حكومات بلادهم، فلم يستطع معظمهم مجاوزة هذا الحد، حتى دعاء الأئمة في الصلوات لإخوانهم الـمُعذَّبين في فلسطين لم يكن متروكًا لحريتهم الشخصية في بعض الدول، وهذه الحالة جعلت الناس يفرحون بمجرد دعاء أو كلمة يصدرها أحد العلماء، علمًا أن مثل هذه الكلمة كانت في أزمنة سابقة لا تعد شيئًا يلتفت إليه، ويعد المكتفي به مُقَصِّرًا، وقد ظهر ذلك أيضًا في العون المالي –فضلًا عن العسكري- الذي يرغب بعض المسلمين بتقديمه لإخوانهم الفلسطينيين، فإن هذا الدعم يجب أن يكون وفق ما تحدده الحكومة، وعبر قنواتها الرسمية، وإلا فالعقوبات –وأحيانًا القاسية- تنتظر المخالفين.
- الحدود الجغرافية: كانت الأرض كلها -إلى حدٍّ كبيرٍ- وطنًا لكل إنسان، يسافر ويستقر حيث يشاء، ولا يُغْلَق في وجهه باب، ولا تُقَيِّد حركته أسلاكٌ شائكة، ولا حدودٌ مانعةٌ، وهو ليس بحاجة لا لجواز سفر، ولا لطلب إقامة، ولا يسعى للحصول على جنسية، مما كان يمنح الإنسان قوة في مواجهة السلطة الحاكمة، فيترك الوطن الذي يؤذيه رغم صعوبة الهجرة على النفس البشرية، لكن الأمر كان متاحًا لمن يرغب، ولمن ضاقت به بلده، أما اليوم فالأمر غير متاح، وكيف سيهاجر الإنسان من بلد إلى بلد؟! ويمكن للسلطات منعه من السفر، وبإمكان سلطات الدولة الأخرى عدم استقباله، وإرجاعه من حيث أتى، أو حجزه في المطار، في قصص كثيرة تشير لمعاناة إنسان اليوم في السفر والتنقل، وحتى لو تمكن من الهجرة إلى دولة أخرى، فإن الصعوبات والتحديات التي يعاني منها المهاجرون كثيرة، وربما تكون مساحة الحرية في بلده التي هاجر منها أكثر من البلد التي هاجر إليها.
وقد كان العلماء قديمًا يطوفون الأرض لطلب العلم بكل يسر وسهولة، سوى الصعوبات التي تقتضيها طبيعة السفر في تلك الأزمان، وصار من العيب ألا ترحل في سبيل طلب العلم، فقد كان العلماء يتنقلون بين البلدان كما يتنقل الأطفال اليوم في غُرَفِ المدرسة الواحدة، لا يمنعهم مانع، وكانت تستقبلهم مساجد العالم الإسلامي بخيرات واقفيها، وتحنو عليهم بكرم أهليها[31]، والسفر اليوم مسموح أمام الراغبين به، لكن بتكلفة ليست قليلة، ويشترط ألا تكون معارضًا للسلطة، أو ألا يكون لك أي علاقة بالسياسة.
وسهولة السفر والتنقل واتخاذ المكان الذي يرتاح فيه الإنسان، كان يمنح العلماء القدرة على التفلت من أي عملٍ لا يريدونه، ومن رفض مناصرة مَن لا يرونه يستحق ذلك، فقد جاء في سيرة الإمام الشاطبي -شيخ القراءات وناظم الشاطبية- المتوفى سنة590ه، أنه ترك بلاده الأندلس واستوطن مصر، وصبر فيها على فقرٍ شديدٍ، مع أنه كان ضريرًا، فقد طُلب منه أن يكون خطيبًا، فاحتج بالحج، وترك بلده، لأنهم كانوا يلزمون الخطباء بذكر الأمراء بأوصافٍ لم يرها سائغة[32].
ورغم وجود وظائف جيدة للحدود السياسية، إلا أن هذه الحدود استخدمت قيوداً تكبل حرية الناس، وتقهرهم، وتزيد من القدرة على السيطرة عليهم، ويزداد ذلك في ظل التعاون الأمني بين الدول المختلفة، فقد تعيد السلطات بعض الهاربين من ظلم دولهم إليها مرة أخرى، ليساموا فيها سوء العذاب.
وهذه الحدود -وما تبعها من جنسيات، وجوازات سفر، وإذن بالدخول- جعلت وصول المسلمين إلى فلسطين لنصرة أهلها أمرًا صعبًا، ففي ظل حرب الإبادة وعندما اشتد الحصار، وزاد التجويع، واحتاج أهل غزة إلى الطعام، والدواء، والأطباء، والخيام، بل والأكفان، وغيرها الكثير من الحاجات الإنسانية، لم يتمكن إخوانهم من اجتياز تلك الحدود الكثيرة، ولم تأذن الأنظمة العربية لهم بذلك، وكانت الشاحنات تمنع من الدخول إلى غزة المحاصرة، ومن ثَمَّ لم يتمكن علماء الأمة من التواجد في جبهات الجهاد في وقت الحرب الدامية فهو أمر غير ممكن، كما لم يستطيعوا تنظيم المسيرات بالقرب من حدود الكيان الصهيوني في الدول المجاورة له ليزعجوا الكيان فضلًا عن أن يقاتلوه، وهذا كله جعل الكيان يقوم بجرائمه ضد الشعب الأعزل، وهو يشعر بالأمان.
- القومية: يقول وائل حلاق: “الدولة الحديثة دائمًا دولة قومية؛ لأن الدولة من دون القومية ليس لها فرصةٌ للبقاء”[33]، وتسمى الدولة الحديثة بالدولة القومية، وقد وُظِّفت القوميات في العالم الإسلامي توظيفًا سيئًا إلى حدٍّ ما، فهي كانت أشبه بإحياء العصبيات القديمة التي جاء الإسلام لمحاربتها، فقد قال رسول اللَّهِ r: “لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ”[34]، وقد استغل الاستعمار وأعوانه القوميات في إذكاء الصراعات، لإضعاف الأمة، وتفريقها، والاستفراد بدولها واحدة واحدة، وقد نجحت هذه السياسة إلى حد كبير، مما جعل بعض أبناء المسلمين يعيش منسلخًا عن بقية أبناء أمته، فلا يفرح لفرحهم، ولا يتوجع لحزنهم، حتى جاء –بدعم من الاحتلال وبعض الأنظمة- من يقول: إن فلسطين ليست قضيتي، بعد أن كانت فلسطين قضية الأمة، وقلبها النابض، وصارت بعض الأنظمة تعتبر أن القضية الفلسطينية عائقٌ أمام تطبيعها مع دولة الاحتلال.
ولم توفر الأنظمة الحاكمة أي وسيلة من وسائل التربية الوطنية إلا واستخدمتها لترسيخ الولاء للممسكين بالسلطة، بدعوى أنه ولاء للوطن، وأصبح المطلوب من الناس أن يموتوا في سبيل الوطن أو بالأدق في سبيل حكام الوطن، وارتفعت شعارات تنادي بحياة الوطن لا بحياة الإنسان أو المواطن[35].
وأمام صوت عصبية القوميات المرتفع، ضعفت الأخوة الإيمانية والوحدة الإسلامية، ولم يجد نداء وجوب النصرة آذانًا صاغية، وانعكس ذلك على الفقهاء، فهناك من أهل العلم والوعظ مَن أصبح يقدم قوميته، ومصلحة بلده على دينه، فلا يرى واجبًا عليه تحريض قومه على الدفاع عن الشعب الفلسطيني، ويرى أن أي جهدٍ تقوم به دولته فهو كافٍ، وأما أهل العلم الذين لم يقعوا في أسر القوميات، فإنهم يواجهون صعوبة في تحريك شعوب الأمة نحو نصرة فلسطين، وفي إصدار فتاوى ضد أي نظام لا يقدم المطلوب منه تجاهها.
- البناء الاجتماعي للدولة الحديثة: أدركت الدولة الحديثة أن إمكانية إقامة بنيانها على البناء الاجتماعي الموجود قبلها صعب، فلم تكتفِ باستحداث أبنية قانونية جديدة منفصلة عن الأبنية الاجتماعية المتوارثة، بل سعى الفكر الغربي لخلخلة وتفكيك البناءات الاجتماعية القائمة، وإعادة تنظيمها، لتحل الدولة محل الأسرة والعائلة، ولذلك تمت إعادة تعريف الأسرة، بما يخدم الدولة الحديثة، والواقع يشير إلى أن الأسرة الحديثة تنتج أفرادًا مغتربين، وأنانيين[36].
ومن أجل إدراك حجم التغيير الذي حدث في العالم الإسلامي، يجب الانتباه لما تمثله الأسرة من قوة في كافة الصعد، أهمها أن الأسرة تشكل عصبًا مهمًا في بنيان الأمة، فهي الوحدة الأساسية لإنتاج القيم التي تُتَوَارث عبر الأجيال، مما يضمن بقاء الهوية الحضارية للأمة واستمرارها، فغرس القيم وتوجيه المجتمع المسلم يبدأ من الأسرة، ومعها أو قبلها المؤسسة الدينية، مما يؤدي إلى الحفاظ على القيم والهوية، ولا يتحكم النظام السياسي في هذا المجال، أما في مشروع الحداثة الغربي، فمؤسسات الدولة -التعليمية والإعلامية والقانونية- هي المنظم والمتحكم الأول في قيم المجتمع ومعاييره، وهي قادرة على صياغة الأفراد وجماعة المجتمع وفق معاييرها، مما يعني أن القيم والأنماط السلوكية والهوية يتحكم فيها النظام السياسي[37]، والناس في الدولة الحديثة بنموذجها الغربي هم أبناء الدولة ونظامها السياسي، أكثر من كونهم أبناء والديهم، وعائلاتهم، ومجتمعهم.
وأمام ذلك، فقد أمست الأمة أمام علماء هم أبناء الدولة الحديثة أكثر من كونهم أبناء دينهم، وأمتهم، وهذا ينعكس على نظرتهم للنوازل المختلفة، وإن ضعف الأسر والعائلات والقبيلة أمام قوة الدولة الحديثة أفقد العلماء الحماية والمناصرة من بطش الدولة وظلمها، فالدولة الحديثة لا تحترم نموذج أبي طالبٍ مثلًا وهو يدافع عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، بل تبطش بهما معًا.
- روح هذه الدولة: لن يتوسع البحث في الحديث عن فكر الدولة الحديثة، وإنما سأذكر جملة يسيرة عنه، فهذه الدولة يجري الفكر الليبرالي الرأسمالي في كل مؤسساتها مجرى الدم في العروق، والواقع يثبت أن ادعاء حياد هذه الدولة فيما يتعلق بالأديان هي فكرة غير صحيحة، فالليبرالية أشبه بدين جديد لا يقبل وجود دين غيره، وهذا الفكر يتعارض على طول الخط مع الإسلام، فالإسلام ليس دينًا روحيًا يتعلق بالجانب الخاص والفردي، ولا يقبل أن يحبس في المساجد، بل هو دين الحياة كلها، ودولته ينبغي أن تكون غايتها الكبرى هي تعبيد الناس كلهم لله، والسير وفق هداه سبحانه وتعالى، ولذلك فإن الفروق عديدة بين الدولة الإسلامية والدولة الحديثة، فالنظام الأخلاقي، والقانوني، والاجتماعي يختلفان في كلتيهما، والدولة الحديثة تحدث نوعًا من الحرمان الروحي، وتفصل بين الأخلاق والسياسة والاقتصاد، مما يورث المجتمعات نتائج وخيمة، ومن ثَمَّ فإن نداء الفقيه بتطبيق الشريعة بالصورة المثالية –بما فيها من أخوة إيمانية ونصرة للمستضعفين ودفاع عن المقدسات- لا يجد استجابة في واقعٍ لا يسمح بالحد الأدنى أصلًا.
- احتكار القوة العسكرية: تسيطر الدولة الحديثة على كل المقدرات العسكرية، وهذا يجعلها صاحبة القوة الوحيدة، ويجعل إمكان تغيير الحكومات -إن لم يحدث سلمًا- صعبًا جدًا، فلا بد لنجاح أي تغيير من أن يَصْدر أو يُدْعم من الجيش، أو من قوة خارجية، وهو ما واجته الثورات في العالم العربي.
وهذه القوة التي تملكها الدولة الحديثة تضعف قدرة الأفراد أو الجماعات على تغيير النظام العاجز والمتآمر، وتصبح أي جماعة ترغب بنصرة الفلسطينيين ضعيفة، فالقوة في يد الدولة فقط، وقلما تملك جهةٌ أخرى قوةً عسكريةً مؤثرة دون موافقة الدولة، ورغم أن احتكار الدولة لاستخدام السلاح له إيجابيات عديدة، إلا أنه أطلق يد الدولة لتفعل ما تشاء دون أن تجد من يردعها، أو يوجب عليها الاعتدال، وليس معنى هذا الكلام الدعوة للحرب الأهلية أو للفوضى، بل المراد أن يكون هدف السلاح حماية الشعوب وليس حماية أنظمة الاستبداد، وأن يوجه السلاح لصدور أعداء أمتنا، وليس إلى صدور أبنائها، خاصة وأن أموالاً كثيرة من أموال الأمة تُدفَع لشرائه، وأن تتعاون كل الجيوش الإسلامية لتدافع عن كرامة الأمة، وتحرير مقدساتها.
وهذه القوة العسكرية التي تملكها الدولة الحديثة وحدها تجعلها قادرة على أن تبطش بالعلماء الذين يعارضونها، فلديها القدرة على قتل العلماء وسجنهم، وتعذيبهم، بمحاكمة أو بدون محاكمة.
- النظام الاقتصادي: أدرك بعض الفقهاء سطوة سلاح المال في يد السلطة، فحرصوا على الاستغناء عنها، فحينما جَاءَ رَجُلٌ إِلَى سفيانٍ الثَّوْرِيِّ، فَقَالَ: يا أبا عَبْدِ اللهِ تمسك هذهِ الدَّنَانِيرَ؟ فقالَ: “اسْكُتْ لولَا هَذِهِ الدَّنانيرُ لَتَمَنْدَلَ بِنَا هَؤُلَاءِ الْمُلُوكُ”، وقال أيضًا: “كان المـَالُ فِيمَا مضى يُكرَه، فَأَمَّا اليومَ فهُو تُرْسُ الْمُؤمن”، وقال: “مَنْ كان فِي يده مِنْ هَذِهِ شَيْءٌ، فَلْيُصْلِحْهُ، فإِنَّهُ زَمَانٌ مَن احتاجَ كَانَ أوَّلَ مَا يَبْذُلُ دِينه”[38]، وإذا كانت لدى الفقيه القدرة على الاستغناء المالي عن الدولة قديمًا، لاعتماده على التجارة، أو على الأوقاف التي كانت تنفق على حلق العلم، فضلاً عن قلة متطلبات الحياة قديمًا، فإن الاستغناء عن الدولة اليوم صعبٌ إلى حد كبير، فيصعب على العالم أن يعيش بعيدًا عن الوظائف الرسمية، ولم تعد متطلبات الحياة كما كانت سابقًا، إضافة لما عمد إليه النظام الرأسمالي من زيادة السلوك الاستهلاكي لدى الناس، فتحولت الكماليات إلى حاجيات وربما ضروريات، ثم إن هناك مجموعة من الأنظمة والآليات التي تدفع الإنسان لمزيد من الاستهلاك في كافة المجالات.
وقد سعت الدولة الحديثة لتجفيف المنابع المالية التي تمكن المجتمع من الاستقلال عنها، وقد ظهر هذا جليًا في التعامل مع الأوقاف، فكلما قويت مؤسسات الدولة الحديثة، زاد ميلها نحو الرغبة في السيطرة على الأوقاف، وهذا أدَّى إلى تجفيف نهر الخير الاجتماعي وهو الوقف، مما أضرَّ بالمجتمع والدولة معًا[39]، والدولة الحديثة خاصة حينما تبتلى بالمستبدين والفاسدين، فإنها لا تجعل السوق حرةً تسودها أجواء تنافسية أخلاقية عادلة، بل تخنق السوق، وتسيطر عليه، وتأتي بالشركات التجارية الخاضعة لها، فتتحكم في العملية التجارية كلها -الاستيراد والتصدير والتصنيع والأسعار والضرائب- بصورة تفقر أي شركة أو تاجر لا تريده الدولة، وهذا يشكل بيئة طاردة للاستثمار، إضافة للنظام الاقتصادي العالمي الذي تتحكم فيه دول الاستكبار وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، التي تلعب بالسوق والعملات بصورة ماكرة، وهذا كله يجعل الأمن الوظيفي أو المالي للعالِم وأسرته لا يحدث في كثير من الأحيان إلا في ظلال الدولة، وحتى الوظيفة الحكومية -رغم ما فيها من سلبيات- أصبحت أملًا لكثير من أهل العلم، والعمل في وظائف الدولة يفقد الإنسان جزءًا -يقل ويكثر- من استقلاليته، وهذا لا يعني أن كل العلماء العاملين في الدولة يخضعون لها، فهناك فئة حرة تأبى الخنوع، إما لقوة إيمانية أخلاقية تجعلهم يفضلون الفقر والجوع على الخضوع، أو لديهم وسائل مالية مستقلة استطاعت التملص من سلطان الدولة، وقد جاء في سيرة العالم أبي الفضل الجِيلي (ت565ه) أنه دعي إلى الشهادة للخليفة بما لا يجوز، فامتنع من الشهادة، وطرح الطيلسان، وقال: “ما لكم عندنا إلا هذا”[40].
وفي النظام الاقتصادي للدولة الحديثة أشار غانم إلى حدوث انفصال كبير بين الدولة والمجتمع في أغلب الدول النفطية الخليجية، فالنسبة الأكبر من الاقتصاد الوطني بيد شركات أجنبية، فأعقب ذلك مجيء طوفان العمالة الأجنبية الوافدة من بلدان الوفرة السكانية، مما جعل ملامح الهوية الذاتية تضعف حتى على مستوى اللغة، والسلوكيات الحياتية اليومية، إذ تكاد الدولة أن تكون بلا مجتمع[41].
وفي مجتمع هذا حاله يضعف تأثير العلماء، بل يضعف تأثير الدين كله في المجتمعات الاستهلاكية الأنانية، فالإسلام دين الجماعة، والتعاون، والجسد الواحد، ولذلك ستكون قضية الجهاد للدفاع عن النفس صعبةً وشاقةً على هذه الشعوب، فكيف ستنفر للدفاع عن شعبٍ إسلاميٍّ آخر؟! وقد حذَّر رسولنا صلى الله عليه وسلم من الاشتغال بالأعمال الدنيوية على حساب الجهاد في سبيل الله، فقال: “إذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إلَى دِينِكُمْ”[42] ويُحمل الحديث على الاشتغال بالزرع في زمن يتعيّن فيه الجهاد، مما يؤدي لترك الجهاد المتعين، ولا يدل هذا الحديث على كراهية الإسلام للعمل الزراعي، وهو الذي حثَّ عليه وعلى الصناعة والتجارة، فالقوة العسكرية لا بد أن تستند إلى اقتصاد قوي[43].. فكيف إذا كانت بعض الشعوب اليوم لا تشتغل لا بزرع ولا بتجارة بل هي مشغولة بشهوات البطن والفرج، ويسيطر عليها الكسل والاتكالية؟!
- علماء السلطان: تبتلى الأمة بعلماء يبيعون دينهم في سبيل مصالحهم وأهوائهم، غير أن إمكانات الدولة الحديثة اليوم مكنتها من صناعة علماء سلاطين بسهولة، فالناس يتربون في بيئة الدولة الحديثة من المهد إلى اللحد، وربما تقوم بإرسال بعض رجال مخابراتها للتخصص في المجالات الشرعية المختلفة، وتكمن خطورة فقهاء السلاطين اليوم أنهم يشكلون الفقيه البديل، الذي يمكن الدولة من استغلال الدين، واستخدامه في إضفاء الشرعية على أفعالها، والسلطة تغدق على علمائها الأموال، وتفتح أمامهم وسائل الإعلام، وتمنحهم المناصب، وتوظفهم في الجامعات والمؤسسات الدينية المختلفة، مما يمكنهم من أن يقوموا بالدور المطلوب منهم، بينما يكون التضييق والتهميش من نصيب غيرهم.
- استبدادها المضاعف: يكاد المتأمل في واقع الدولة الحديثة أن يصل لقناعة أن هذه الدولة مستبدة بطبعها، وهي تقلص مساحات الحرية الحقيقية أمام الناس، فالإنسان الحديث عبد للدولة الحديثة شاء أم أبى، وعبدٌ للنظام الدولي، وإذا أضفنا لذلك أن تكون السلطة الحاكمة مستبدة، فإن استبدادها سيكون أضعاف استبداد أي حاكم قديم، فالدولة الحديثة طورت أدوات الاستبداد الموروث من الدولة السلطانية، وأضافت إليه ما هو أحدث طرازًا، وأفدح ضررًا[44]، فهي لديها قدرات جبارة تمكنها من إعادة صياغة الوعي العام، ومن الهيمنة على عقل المجتمع ووجدانه، مما فتح شهية الحكام للاستئثار بما هو أبعد من السلطة والثروة، فتطلعوا لاحتكار مواقع الصدارة في الثقافة والرياضة والعلوم والفنون، وقد وسَّعت الدساتير صلاحيات الرئيس وأطلقت يده، وأعفته من المساءلة والمحاسبة، بل وأمسى الدستور، والبرلمان، والصحافة تناقض أهدافها المعلنة[45].
وما جاءت به الدولة الحديثة من الانتخابات، والدستور، والبرلمان، والحريات، والتعدد الحزبي …إلخ، مما هو موجود في الدول الغربية، لم تكن كما هي في الغرب، فهي تشبه ما يحدث في الغرب شكلًا، ولكنها منزوعة الجدوى، تشبهها في الشكل والرسم، وتختلف معها في الوظيفة والرسم، فقد استخدمت في قمع الشعب ووأد حرياته، وهذا كان في الدول الملكية، أو أشباه الجمهوريات، فكلاهما كان عبارة عن ديكتاتوريات[46]، ولذلك؛ فإن الشعوب الإسلامية حُرِمت من إيجابيات الدولة الحديثة، فمعظم الدول الإسلامية تقبع تحت الاستبداد، فلا بقي المسلمون ضمن الدولة القديمة، ولا استفادوا من ميزات الدولة الحديثة، والعالِم المسلم اليوم لم يستفد من الدولة الحديثة ما استفاده علماء الغرب، فلم يتمتع بحرية التعبير عن رأيه، ولا باستقلالية القضاء، ولا حرية التنقل، ولا القدرة على مساءلة رجال الدولة، والمطالبة بمعاقبتهم، وغير ذلك.
11- خضوعها للنظام الدولي: إن مما يزيد من ضعف الدول في العالم الإسلامي خضوعها للنظام العالمي، الذي يعادي الأمة المسلمة، ويسرق خيراتها، ويحتل ديارها بصورة مباشرة وغير مباشرة، وقد وصل النظام العالمي لدرجة من السطوة والجبروت والسيطرة تجعل من الصعب على أي دولة أن تستمر دون اعتراف دولي بها، فالدولة التي لا يعترف بها النظام الدولي، ويحارب من يعترف بها، تعد دولة ضعيفة، وتواجه صعوبات عديدة، بل ستعيش منقطعة عن العالم، مما يجعلها معرضة للزوال في أي لحظة، وعند تأسيس أي نظام سياسي، فإن من أكثر ما يفكر به مؤسسوه هو كيفية الحصول على الاعتراف الدولي[47]، والحصول على الاعتراف يلزم منه الخضوع لهذا النظام في برامجه السياسية، والعسكرية، والاقتصادية، والاجتماعية التي لا تحترم خصوصيات الأمم والشعوب، وما في ذلك من مصادمات لقطعيات الشريعة الإسلامية، ويزيد خطر التغلغل الأجنبي من خلال ما يعرف بالعمل التطوعي الذي تقف خلفه وتموّله وتُوَجِّهه الجهات الأجنبية الساعية لتحقيق أهدافها ومصالحها، مما لا يتفق مع أهداف أمتنا ومصالحها، بينما يتم محاربة المؤسسة الوقفية التي كانت وثيقة الصلة بمجال الفكر، والتنشئة الثقافية، التي تحافظ على القيم المميزة لهوية الأمة[48].
ومن المعلوم أن النظام الدولي الذي تقوده أمريكا وبريطانيا منحاز علنًا وبصورة وَقِحَة للكيان الصهيوني، فأمريكا تقاتل جنبًا إلى جنب مع الكيان، وقد أظهرت حرب الإبادة أن المنظمات الدولية على اختلاف أنواعها، من محكمة العدل، والأمم المتحدة، وغيرها، هي مجرد أدوات في يد الدول المستكبرة، ووجود أشخاص جيدين في إحدى المؤسسات الدولية لا يغير من هذه الحقيقة، فأمريكا تبطل أي قرار يمكن أن يضر بالكيان الصهيوني، أو حتى يوقف جرائمه، بل وتعاقب من يقف ضد الكيان.
وهذه الدول الخاضعة للنظام الدولي، لا تحمي العلماء الذين يدعمون الشعب الفلسطيني ومقاومته، بل قد تلتزم باتفاقيات تجعلهم يعاقبون كل مناصر للقضية الفلسطينية بتهمة دعم الإرهاب، ونظرًا لضعف الأنظمة العربية والإسلامية الحاكمة تجد أنهم يستنكرون الجرائم الفظيعة للاحتلال استنكارًا خجولًا، ويساوون بين الجلاد والضحية، وتقصر هذه الأنظمة الضعيفة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني حتى في إطار ما يسمح به القانون الدولي، ويكفي أن نستذكر أن الدولة التي رفعت دعوى إلى محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني لارتكابه جرائم إبادة في غزة بتاريخ 29/ ديسمبر/ 2023م، لم تكن دولة عربية ولا إسلامية، وإنما هي دولة جنوب إفريقيا، وهو مما يسجل ويشكر لها.
وفي الوقت الذي تدعم فيه أمريكا وبريطانيا الكيان الصهيوني بالمال والسلاح وكل ما يحتاجه، تعجز الدول العربية عن مقاضاة الكيان الصهيوني في المحاكم، هل ستفكر هذه الدول في أن تحرك جيوشها وطائراتها وأساطيلها للدفاع عن الفلسطينيين؟!
12- السيادة: تعد السيادة هي أقوى ما تملكه الدولة الحديثة، إلا أني آثرت ذكرها كآخر الأدوات والوسائل التي تمتلكها، وذلك لأن مجموع ما ذُكر سابقًا هو الذي يمنحها السيادة، وسيادة الدولة الحديثة ذات المرجعية الوضعية تعني في نهاية المطاف: إعلاء ذات الدولة على ما عداها، فهي مستعلية على المجتمع وليست خادمة له، وهي تضحي بالمجتمع نفسه إذا كانت سيادتها محل خطر، فضلًا عن إطاحتها بأي سلطة منافسة لها، سواء كانت هذه السلطة دينية أو اقتصادية أو اجتماعية، فهي لا تحب إلا ذاتها، ولا تقبل شريكًا لها، فهي تشبه إلى حد ما الدولة الإلهية بمعناها في الفلسفة المسيحية الوسيطة، وقد زرعت الدولة الحديثة رعبًا في قلوب الناس من غيابها، فقدمت نفسها ككائن أبدي، وجد ليبقى ويستمر، ولا يمكن العيش بدونه، مع أن الثابت تاريخيًا أن البشرية عاشت في تجمعات بلا دولة، وبلا سلطة مركزية في معظم تاريخ حياتها، ولا يوجد دليل علمي يثبت أن الناس في ظل الدولة الحديثة أكثر سعادة منهم قبل نشوء الدولة بمعناها الحديث[49].
ورغم أن السيادة يجب أن تشكل نقطة تميز للدولة أمام الدول الأخرى، إلا إنها وللأسف الشديد في الدول الإسلامية تبدو وسيلة لخنق الشعوب، واضطهادها، وأما أمام الدولة الخارجية فدولنا مستضعفة، وسيادتها منتهكة، وتتكلم أمريكا بازدراء واحتقار واستضعاف للدول الإسلامية، فلم تحقق الدول العربية الاستقلال الحقيقي، فلا زالت تطلب الحماية من الدول الاستعمارية، وجيوشنا لم تسجل انتصارًا إلا على شعوبها، أما أمام دول الخارج فالضعف يحيط بها من كل جانب.
وتحت شعار احترام سيادة الدولة، يصبح من غير المسموح للأفراد والجماعات داخل الدولة أن يقوموا بأي شيء في سبيل مساعدة الشعب الفلسطيني، وأي تحرك لا ينال موافقتها هو جريمة يعاقب عليها القانون، فالأنظمة الحاكمة لا تكتفي بعدم القيام بالمطلوب منها، بل وتمنع من يحاول القيام بواجبه الشرعي والوطني والأخلاقي.
وبعد ذكر وسائل تأثير الدولة في العلماء ودورهم الجهادي، يتضح أنه من الصعب الحديث عن عالمٍ لا يخضع لتأثير الدولة الحديثة، فهو ابن بيئته، ومحيطه، لكن شتان بين من يخضع مكرهًا لبعض ضغوطها، ومَن يتقدم طوعًا ليكون خادمًا لها، مقدمًا مصلحته الشخصية على مصلحة دينه، وأمته؛ ومن سوء الفهم لهذا البحث أن يُظنَّ أن قيود الدولة الحديثة قدرٌ لا يمكن الخلاص منه، فالتشخيص أول مراحل العلاج، والعلماء مطالبون بكسر هذا الطوق.
الخاتمة:
أولًا: النتائج:
وأما عن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث، فهي:
- لم تأخذ الدولة الحديثة وآثارها في مناحي الحياة المختلفة حقها في الدراسة والبحث، حيث لم يُنتبه لكونها شيئًا مستحدثًا، وأنها تحمل العديد من المشكلات، وإن عدم الانتباه لما تحمله هذه الدولة من فكر وإمكانيات، والتعامل معها على أنها محايدة، جعل بعض المسلمين ينظرون إلى أنه بمجرد السيطرة عليها، فإن أسلمة الدولة والمجتمع تحدث تلقائيًا.
- الدولة الحديثة بهياكلها ونظمها القادمة من الغرب تشكل تحديًا أمام تطبيق الشريعة الإسلامية، وليس من السهولة إقامة النظام الإسلامي على هياكلها، وإن كان التزام الدولة الحديثة بالقيم السياسية الإسلامية ينتج دولًا أفضل من الدول القائمة.
- تختلف الدولة الحديثة عن القديمة في شموليتها التي تتمدد لتصل إلى كافة مجالات الحياة، مما يصعب إمكانية ابتعاد الأفراد والجماعات عنها، وهي لا ترحب بتكوين مؤسسات تطوعية مستقلة استقلالًا حقيقيًا عنها، وقد عملت على تقليص الدور المجتمعي، وهذا جعل قوة الأعمال وضعفها يرجع لمقدار تأييد الحكومة له، وقد ظهر هذا في تعاطف الشعوب ومناصرتها لأهل غزة في معركة طوفان الأقصى، فحتى المظاهرات السلمية تخضع لهوى السلطة إلى حد كبير.
- تُشَكِّل القومية إحدى دعائم الدولة الحديثة، وقد وُظِّفت القوميات توظيفًا سيئًا أضر بالقضية الفلسطينية، حيث أرادت بعض الأنظمة من شعوبها الانكفاء على ذاتها، وترك غيرهم من إخوانهم ممن يعيشون خارج حدودهم الجغرافية.
- سعت الدولة الحديثة لتفكيك الأبنية الاجتماعية المتوارثة، بما فيها الأسرة التي كانت تشكل اللبنة الأهم في المجتمع، وهذا جعل الناس أبناء دولهم أكثر من كونهم أبناء أهليهم، ومجتمعهم، ودينهم، مما مكن الأنظمة الحاكمة من صياغة الأفراد وفق معاييرها، وهذا انعكس سلبًا على العلماء، وأفقدهم بعض عوامل قوتهم.
- احتكار الدولة الحديثة للسلاح العسكري رغم وجود إيجابيات له، إلا أنه مكنها من التحكم في المجتمع كله، فصارت قادرة على اعتقال العلماء، وقتلهم، وصار الجيش في خدمة النظام وليس الشعب، ولم تتحرك جيوش الدول الحديثة في أمتنا لنصرة قضايا الأمة، وخاصة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة.
- يُقَلِّص النظام الاقتصادي في الدول المختلفة اليوم مساحة الحرية لدى الأفراد والجماعات، ولا يصنع سوقًا تنافسية حرةً، بل يتحكم بالسوق كله، ويجعل القدرة على الاستغناء عنه محدودة، وهذا يجعل العالم ساعيًا للحصول على وظيفة في الدولة، مما يقلل من استقلاله، فلا يتمكن من التصريح بآرائه التي تخالف هوى الدولة.
- الدولة الحديثة مستبدة بطبعها إلى حد ما، وإذا حكمها مستبدون، فإن الاستبداد يكون أضعافاً مضاعفة لأي سلطة قديمة، ولم ينعم العالَم العربي بإيجابيات الدولة الحديثة بسبب أنظمة الاستبداد، بل وأمست الانتخابات والدستور والبرلمانات مناقضة لأهدافها في بعض الأحيان.
- إن خضوع الدول اليوم للنظام الدولي يجعلها ضعيفة، وغير قادرة على الخروج عن الإرادة الدولية، لكنها في المقابل تفرض إرادتها –بل إرادة النظام الدولي- على شعوبها، وربما اتخذت قرارات ضد مصالحها، وهذا يجعل المتعاطفين مع القضية الفلسطينية يواجهون الصعوبات، وتوقع عليهم العقوبات.
- تعد السيادة من أهم الأدوات التي تملكها الدولة الحديثة، فهي لا تقبل وجود سلطة منافسة، ولديها الاستعداد للتضحية بالمجتمع نفسه في سبيل سيادتها، ولم تقم الدول الإسلامية بواجبها تجاه فلسطين، بل ومنعت أي أحد من القيام بواجبه من أراضيها، رغم أن سيادة هذه الدول منتهكة أمام الهيمنة الغربية والأمريكية.
ثانيًا: التوصيات:
يوصي الباحث بالتوصيات الآتية:
- يوصي الباحث بتخصيص دراسات تبين آثار الدولة الحديثة في كافة مناحي الحياة.
- يوصي الباحث بتخصيص دراسات لبيان كيفية التخلص من سلبيات الدولة الحديثة، أو كيفية الوصول للدولة الإسلامية المنشودة.
- يوصي الباحث بتخصيص دراسات لبيان أسباب ضعف دور الأمة الإسلامية في مناصرة الشعب الفلسطيني في حرب الإبادة.
قائمة المراجع
- ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني- مجموع الفتاوى، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، المدينة المنورة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، د. ط، 1416هـ/ 1995م.
- ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني- إنباء الغمر بأبناء العمر، تحقيق: حسن حبشي، مصر، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية – لجنة إحياء التراث الإسلامي، د. ط، 1389ه/ 1969م.
- ابن رجب الحنبلي، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي، ذيل طبقات الحنابلة، تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، الرياض، مكتبة العبيكان، ط1، 1425ه/ 2005م،
- ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي- رد المحتار على الدر المختار، بيروت: دار الفكر، ط2، 1412ه/ 1992م.
- ابن العماد، أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري الحنبلي- شذرات الذهب في أخبار من ذهب، حققه: محمود الأرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط، دمشق وبيروت، دار ابن كثير، ط1، 1406ه/ 1986م.
- ابن القطان، أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي- الإقناع في مسائل الإجماع، تحقيق: حسن فوزي الصعيدي، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، ط1، 1424ه/ 2004م.
- ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي- البداية والنهاية، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، القاهرة، دار هجر، ط1، 1418ه/ 1998م.
- أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني- سنن أبي داود، تحقيق: شعَيب الأرنؤوط ومحَمَّد كامِل قره بللي، دار الرسالة العالمية، ط1، 1430ه/ 2009م.
- أبو غدة، عبد الفتاح- صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل، بيروت، دار البشائر الإسلامية، ط6، 1421ه/ 2000م.
- الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، مصر، السعادة، د.ط، 1394ه/ 1974م.
- البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه المعروف بصحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط1، 1422هـ.
- حبيب، رفيق- الأمة والدولة بيان تحرير الأمة، القاهرة، دار الشروق، ط1، 1421ه/ 2001م.
- حلاق، وائل- الدولة المستحيلة: الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي، ترجمة: عمرو عثمان، الدوحة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ط1، 2014م.
- الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي- سير أعلام النبلاء، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط3، 1405ه/ 1985م.
- السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي- طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق: محمود محمد الطناحي، وعبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط2، 1413ه.
- الشنقيطي، محمد المختار- الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية: من الفتنة الكبرى إلى الربيع العربي، الدوحة، منتدى العلاقات العربية والدولية، ط1، 2018م.
- عزت، هبة رءوف- الخيال السياسي للإسلاميين ما قبل الدولة وما بعدها، بيروت، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ط2، 2015م.
- عليش، محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، دار المعرفة، د. ط، د. ت.
- العمري، أكرم ضياء- فقه الجهاد، الرياض، دار كنوز إشبيليا، ط1، 1433ه/ 2012م.
- غانم، إبراهيم البيومي- الأوقاف والسياسة في مصر، القاهرة، دار الشروق، ط1، 1419ه/ 1998م.
- غانم، إبراهيم البيومي- ميراث الاستبداد، القاهرة، نيو بوك للنشر والتوزيع، ط1، 2018م.
- الغزالي، محمد- هموم داعية، الجيزة، نهضة مصر، ط8، 2008م.
- القرضاوي، يوسف- فقه الجهاد دراسة مقارنة لأحكامه وفلسفته في ضوء القرآن والسنة، القاهرة، مكتبة وهبة، ط1، 1430ه/ 2009م.
- الكيلاني، ماجد عرسان- هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس، رام الله: مركز بيت المقدس للأدب والترجمة، د. ط، د. ت.
- مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهور بصحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ط، د.ت.
- المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي- السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1418ه/ 1997م.
- هويدي، فهمي- خيولنا التي لا تصهل، القاهرة، دار الشروق، ط3، 2008م.
- ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي- معجم البلدان، بيروت، دار صادر، ط2، 1995م.
***************************
************
لتحميل العدد 14 أو أي بحث ضمنه:
——————–
لقراءة جميع الأعداد مع تفاصيل الأبحاث ضمنها:
——————-
لتحميل جميع الأعداد المنشورة من (مجلة المرقاة المحكمة) بنسخة pdf:
[1] طالب دكتوراه في قسم الفقه وأصول الفقه، كلية عبد الحميد أبو سليمان لمعارف الوحي والعلوم الإنسانية، الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا
[2] اندلعت معركة طوفان الأقصى يوم السبت الموافق 7/10/2023م بين قوات الاحتلال الصهيوني والشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتعد هذه الحرب هي الأعنف في تاريخ الصراع، فهي حرب إبادة إذ قتلت قوات الاحتلال عشرات الألوف من الفلسطينيين، أغلبهم من المدنيين، وجرحت عشرات الألوف، وأجبرت مئات الألوف على النزوح القسري من بيوتهم، إضافة إلى ما أحدثته من دمارٍ كبيرٍ في المساكن، والبنية التحتية، والمشافي، والجامعات، والمدارس، والمساجد، ولم تقتصر الحرب على قطاع غزة، بل شملت الضفة الغربية، ولبنان، ولا تزال هذه الحرب مستمرة حتى كتابة هذا البحث، ورغم حدوث تهدئة لقرابة شهرين، فقد شنت طائرات الاحتلال الصهيوني هجومًا غادرًا فجر الثلاثاء 18/ مارس/ 2025م، قتلت فيه مئات الفلسطينيين النائمين في بيوتهم.
[3] ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي- البداية والنهاية، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، القاهرة، دار هجر، ط1، 1418ه/ 1998م، 13/ 611.
[4] مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهور بصحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ط، د.ت، كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، 3/ 1495، ح1876.
[5] انظر: الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي- سير أعلام النبلاء، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط3، 1405ه/ 1985م، 10/ 225- 227، وصِقِلِّيَّةُ: بثلاث كسرات وتشديد اللام والياء أيضًا مشددة، وبعض يقول بالسين، وأكثر أهل صقلّيّة يفتحون الصاد واللام: من جزائر بحر المغرب مقابلة إفريقية. انظر: ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي- معجم البلدان، بيروت، دار صادر، ط2، 1995م، 3/ 416.
[6] الذهبي- سير أعلام النبلاء، 16/ 213.
[7] انظر: المرجع السابق، 8/ 379-421، ولمطالعة بعض أخبار جهاده. انظر 8/394، 8/408.
[8] انظر: السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي- طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق: محمود محمد الطناحي، وعبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط2، 1413ه، 2/ 226.
[9] انظر: ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني- إنباء الغمر بأبناء العمر، تحقيق: حسن حبشي، مصر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية – لجنة إحياء التراث الإسلامي، د. ط، سنة 1389ه/ 1969م، 2/ 492؛ ابن العماد، أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري الحنبلي أبو الفلاح، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، حققه: محمود الأرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط، دمشق وبيروت، دار ابن كثير، ط1، 1406ه/ 1986م، 9/ 157.
[10] عليش، محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، دار المعرفة، د. ط، د. ت، 1/ 392.
[11] انظر: السبكي- طبقات الشافعية الكبرى، ج8، ص243؛ المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي- السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1418ه/ 1997م، 1/ 407.
[12] يؤخذ على الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله أنه في كتبه خاصة كتاب إحياء علوم الدين لم يتطرق للأخطار الخارجية، ولا للاحتلال الصليبي الذي تتعرض له الأمة، بل ركز على السعادة الفردية لا العامة، وهناك من يلتمس العذر له بأنه ركز جهده على تربية الأمة، وتخليصها من سلبياتها، لتكون بعد ذلك قادرة على مواجهة العدو. انظر: الكيلاني، ماجد عرسان- هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس، رام الله، مركز بيت المقدس للأدب والترجمة، د. ط، د. ت، ص143-147؛ الشنقيطي، محمد المختار- الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية: من الفتنة الكبرى إلى الربيع العربي، الدوحة، منتدى العلاقات العربية والدولية، ط1، 2018م، ص502، 503.
[13] الغزالي، محمد- هموم داعية، الجيزة، نهضة مصر، ط8، 2008م، ص128.
[14] انظر: القرضاوي، يوسف- فقه الجهاد دراسة مقارنة لأحكامه وفلسفته في ضوء القرآن والسنة، القاهرة، مكتبة وهبة، ط1/ 1430ه/ 2009م، 1/ 545.
[15] انظر: ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني- مجموع الفتاوى، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، المدينة المنورة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، د. ط، 1416هـ/ 1995م، 5/ 538؛ ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي- رد المحتار على الدر المختار، بيروت: دار الفكر، ط2، 1412ه/ 1992م، 4/ 124.
[16] متفق عليه: البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه المعروف بصحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، (دار طوق النجاة، ط1، 1422هـ)، كتاب الجهاد والسير، باب فضل من جهَّز غازيًا أو خلفه بخير، 4/ 27، ح: 2843؛ مسلم- صحيح مسلم، كتاب الإمارة، بابُ فضلِ إعانةِ الغازي في سبيلِ اللهِ بِمَرْكُوبٍ وغيرِهِ، وخِلافتِهِ فِي أهلِهِ بخير، 3/ 1506، ح: 1895، واللفظ لمسلم.
[17] البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي- كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الكتب العلمية، د. ط، د. ت، 3/ 103.
[18] انظر: ابن القطان، أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي- الإقناع في مسائل الإجماع، تحقيق: حسن فوزي الصعيدي، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، ط1، 1424ه/ 2004م، 1/ 60.
[19] عزت، هبة رءوف- الخيال السياسي للإسلاميين ما قبل الدولة وما بعدها، بيروت، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ط2، 2015م، ص125.
[20] انظر: عزت- الخيال السياسي للإسلاميين، ص10، 127.
[21] انظر: حلاق، وائل- الدولة المستحيلة: الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي، ترجمة: عمرو عثمان، الدوحة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ط1، 2014م، ص30؛ هبة عزت- الخيال السياسي للإسلاميين، ص72– 74، 126؛ غانم، إبراهيم البيومي- ميراث الاستبداد، القاهرة، نيو بوك للنشر والتوزيع، ط1، 2018م، ص11.
[22] انظر: غانم- ميراث الاستبداد، ص9، 10.
[23] انظر: حلاق- الدولة المستحيلة، ص19، 20، 276، 293.
[24] انظر: حلاق- الدولة المستحيلة، ص19، 24، 33، 284.
[25] رفض الشنقيطي أطروحة وائل حلاق واصفًا إياها بأنها طرحٌ عدميٌّ، يظلم الدولتين الإسلامية والحديثة. انظر: الشنقيطي- الأزمة الدستورية، ص497-505.
[26] انظر: الشنقيطي- الأزمة الدستورية، ص499، 505.
[27] انظر: غانم، إبراهيم البيومي- الأوقاف والسياسة في مصر، القاهرة، دار الشروق، ط1، 1419ه/ 1998م، ص17، 31.
[28] انظر: حلاق- الدولة المستحيلة، ص208، 209.
[29] الغزالي- هموم داعية، ص11.
[30] انظر: غانم- الأوقاف والسياسة، ص25، 47.
[31] انظر: أبو غدة، عبد الفتاح- صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل، بيروت، دار البشائر الإسلامية، ط6، 1421ه/ 2000م، ص381، 382.
[32] انظر: الذهبي- سير أعلام النبلاء، 21/ 261- 263.
[33] حلاق- الدولة المستحيلة، ص207.
[34] أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني- سنن أبي داود، تحقيق: شعَيب الأرنؤوط ومحَمَّد كامِل قره بللي، دار الرسالة العالمية، ط1، 1430ه/ 2009م، كتاب الأدب، باب في العصبية، من حديث جبير بن مطعم t، قال أبو داود: هذا مرسل عبد الله بن أبي سليمان لم يسمع من جبير، وضَعَّف إسناده المحققان، 7/ 441، 442، ح:5121.
[35] انظر: غانم- ميراث الاستبداد، ص45.
[36] انظر: حلاق- الدولة المستحيلة، ص34، 196، 199، 200؛ حبيب- الأمة والدولة، ص9، 10، 18.
[37] انظر: حلاق- الدولة المستحيلة، ص78، 248؛ حبيب- الأمة والدولة، ص18، 19.
[38] الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، مصر، السعادة، د.ط، 1394ه/ 1974م، 6/ 381.
[39] انظر: غانم- الأوقاف والسياسة، ص164، 384، 514.
[40] ابن رجب الحنبلي، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي، ذيل طبقات الحنابلة، تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، الرياض، مكتبة العبيكان، ط1، 1425ه/ 2005م، 2/ 233، والطَّيلسان لباسٌ كان يخلعه الخليفة على العالم. انظر: أبو غدة- صفحات من صبر العلماء، ص188.
[41] انظر: غانم- ميراث الاستبداد، ص249.
[42] أبو داود- سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في النهي عن العينة، 5/ 332، ح3462، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وإسناده حسن.
[43] انظر: العمري، أكرم ضياء- فقه الجهاد، الرياض، دار كنوز إشبيليا، ط1، 1433ه/ 2012م، ص36.
[44] انظر: غانم- ميراث الاستبداد، ص8.
[45] انظر: هويدي، فهمي- خيولنا التي لا تصهل، القاهرة، دار الشروق، ط3، 2008م، ص213؛ غانم- ميراث الاستبداد، ص259-262.
[46] انظر: هويدي- خيولنا التي لا تصهل، ص95-98.
[47] هناك من يرى أن أحد مكونات الدولة اليوم -إضافة للأرض والشعب والسلطة السياسية- الاعتراف من جانب أشخاص القانون الدولي بها. انظر: غانم- ميراث الاستبداد، ص219.
[48] انظر: غانم- الأوقاف والسياسة، ص19، 324.
[49] انظر: غانم- ميراث الاستبداد، ص21، 28، 36، 231-235.